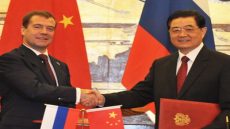بقلم: منذر عيد الزملكاني
بقلم: منذر عيد الزملكاني
انطلقت الثورة السورية دون تمهيدات فكرية ولا تنظيمية، وغاب عنها الأب الروحي والقائد المتقدم. لقد تنكر لها وتبرأ منها معظم دعاة ومؤيدي الثورات من قوميين وماركسيين وبعض اليساريين في الوطن العربي والعالم.. نشأت فقيرة وكبرت يتيمة.. أشعلها الشباب بحماسهم واتقادهم بدافع من مظالمهم وقهرهم، متطلعين بشغف إلى نجاحات من سبقوهم في تونس ومصر دون التأمل في اختلاف الظروف وخصوصية الوضع السوري في المنطقة وفي العالم أجمع.
إن الحالة في سوريا متشعبة جغرافيا وسياسيا داخليا وخارجيا.. فعلى مدى عقود تم ربط سوريا بتعقيدات سياسية داخلية وخارجية.. لقد تم إغراقها في شد داخلي وشد خارجي على السواء لا يُرجى لها إلا دوام حالها. من هنا، نعلم أن حافظ الأسد عندما رفع شعار «إلى الأبد» كان على ثقة تامة بتنفيذه، بعد أن وضع أسسه بفضل خبراء في السياسة والاجتماع من الشرق والغرب، ومشى فعليا في تحقيقه، ونجحت أولى مراحله من خلال توريث سوريا لابنه بشار الأسد. ولا يخفى على أحد أن بشار الأسد كان على النهج نفسه، لكن ليت شعري ما أكثر الذين لا يشعرون بالأحداث إلا عند وقوعها.
لقد أصرت الثورة في سوريا على مسيرتها السلمية لمدة 6 أشهر رغم أن سلميتها قد فشلت من أول يوم تدفقت فيه الدماء في حوران الأبية، وحق لها أن تفشل عندما نتأمل في سياسات النظام منذ خمسين سنة ونقرأها بتمعن وتعقل.. فمنذ عقود والنظام يعد العدة سرا وعلانية لهذا اليوم وذلك عبر تحويل جيش الوطن والأمة إلى جيش طائفي عائلي من خلال تمكين موالين له ومن صلبه في القيادات العليا والمتوسطة. فكيف لنظام يسجن امرأة، هي شيماء، وابنها لسنين رهينتين من أجل الضغط على والدها، أن يتردد في قنص الأطفال وتعذيبهم في المعتقلات؟ وكيف لمن أعطى أوامره قبل أكثر من ثلاثين عاما لكبار المهندسين الذين أشرفوا على تسوية قمة جبل قاسيون بأن يجعلوها صلبة قادرة على تحمل الدبابات في نية مبيتة لقصف دمشق وما حولها إن ثارت ثائرتها عليه.. كيف له أن يستجيب بمدنية وحضارة لنداءات الحرية والكرامة؟ لقد أعد النظام لهذا اليوم.. فماذا أعددنا نحن؟
لقد ولدت الاستراتيجية السلمية في ثورتنا ميتة وحملناها ميتة لستة أشهر على أكتاف خمسة آلاف شهيد أو يزيد وعشرات الآلاف من المعتقلين الذين لم يقاوموا آلة النظام إلا بحناجرهم وكلماتهم. ولو أنها استمرت في سلميتها لدفنت ثورتنا ومعها كل من كان يحملها وكل أحلام الحرية والكرامة التي نادوا بها. يبين الدكتور عبد الرزاق عيد أن غاندي صاحب نظرية النضال السلمي (اللاعنفي)، بعد أن وضع العديد من القواعد المبدئية للنضال السلمي الرافض للعنف، اعتبر أن كل المبادئ السلمية المتعددة التي وضعها شروطا لهذا النضال السلمي، لا قيمة لها من الناحية الإجرائية والفعلية إلا إذا كانت في مواجهة «عدو مدني حضاري» له منظوماته المدنية والقانونية والحقوقية والأخلاقية، لكي تحرج هذا العدو مبدئيا وأخلاقيا وإنسانيا أمام القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية التي يلتزم بها إنسانيا؛ بل والتي ساهم بوضعها.
وهنا يمكن التفريق بين عدو مدني حضاري وعدو همجي غير إنساني، لكن وسائل مقاومة ومقارعة كل منهما تختلف في بعض الأحيان، خصوصا في هذا الوقت من التاريخ؛ حيث الرأي العام والأخلاق في السياسية الدولية وحقوق الإنسان وغيرها تلعب دورا كبيرا في السياسة الداخلية والخارجية للدول المتمدنة. لكن النظام الذي لا ينتمي إلى منظومة أخلاقية ولا قانونية لا تنفع معه المقاومة السلمية، فهو في الإجرام ليس لديه حدود. لذلك، فإن النظام الأسدي في سوريا عندما تدفق المتظاهرون السلميون (نحو ثلاثمائة ألف متظاهر) القادمون من دوما وحرستا وعربين وسقبا وكفربطنا وحمورية وزملكا باتجاه مركز العاصمة دمشق في الجمعة العظيمة بتاريخ 22 – 4 – 2011 بعيد انطلاق الثورة، للمرابطة في ساحاتها الكبرى عمد إلى تفريقهم بالنار، واستشهد وقتها العديد من الشبان، لم يفعل ذلك خوفا من امتلاء الساحات الكبيرة في دمشق بالمتظاهرين السلميين المنادين بالحرية والكرامة على غرار ما حدث في تونس ومصر، وإنما كان يريد تجنب ارتكاب مجزرة كبيرة بحقهم في تلك الساحات يمكن أن تحرجه دوليا.. وكان النظام دون شك فاعلها فيما لو وصلوا إليها. عند هذا المشهد، كان يجب أن تنتهي استراتيجية السلمية بوصفها استراتيجية أساسية في ثورتنا ما دام النظام يصيب فينا ولا نصيب فيه، وهو الذي لا يتحرج من فعل ذلك لا أخلاقيا ولا إنسانيا، ولا عربيا ولا دوليا. ومن ثم، فإنه ليس من العدل أن نقدم الأرواح والدماء في سوق الصراع سهلة رخيصة وهي الغالية الكريمة.
لذلك، فإن الذي وضع الثورة في مسارها الصحيح هم طلائع المنشقين عن الجيش الطائفي من أمثال القشعمي والخلف وهرموش والأسعد وعبد الرزاق طلاس وغيرهم. وفي الحقيقة، الثورة السورية تبلورت استراتيجيتها الجديدة والصحيحة عندما قام المقدم المقدام حسين هرموش بتشكيل «لواء الضباط الأحرار» الذي تطور لاحقا إلى «الجيش السوري الحر» بقيادة العقيد رياض الأسعد وجعله غطاء للثوار والعسكريين على حد سواء. هذه الاستراتيجية هي التي أعطت لثورتنا نعمة البقاء والاستمرارية لأنها أصابت النظام بنزف دائم لن يلتئم إلا بسقوطه. ولذلك كان خطف المقدم حسين هرموش من قبل النظام، لأنه هو من قلب اتجاه الثورة ووضعها في طريق نصرها المحتوم وليس أي شخص آخر من ثوار أو معارضين سياسيين أو عسكريين منشقين. لكن هذه الاستراتيجية التي وضعنا عليها حسين هرموش قبل اختطافه تنكر لها أغلب معارضينا السياسيين لاحقا وحاولوا النأي بأنفسهم عنها، بل وعمدوا إلى إفشالها تحت ذريعة متابعة المسيرة السلمية للثورة. وكلنا يتذكر كيف تلكأ المجلس الوطني في دعم الجيش الحر، وما كان ليدعمه لولا الضغط الشعبي الكبير.
أما الذين يريدون أن تعود الثورة إلى سلميتها تحت وطأة هذا النظام وينعتون أبطال الجيش الحر من ثوار وعسكريين بما هو غير لائق ويتربصون بزلاتهم وأخطائهم، فهم، إن صدقت نياتهم، لا يفقهون سنة الله في التدافع بين الخلق ولا سنته في التدافع بين الأمم.
ورغم أن الاستراتيجية التي خطها رمز الثورة السورية حسين هرموش مؤدية إلى النصر، بإذن الله، لا محالة، فإن عوائق قد اعترضتها في الأشهر القليلة الماضية أبطأت من حركتها وأدخلتها في خضم متاهات زادت من تكلفة الثورة وأطالت مشوارها، خصوصا عندما تم فتح جبهة مدينة حلب على هذا الشكل.. فمدينة حلب رغم أهميتها العظمى عند النظام، فإنها لا تقرر مصيره. ولو أن معشار الجهود التي بذلت في حلب تم بذلها في ريف دمشق المحيط بالعاصمة استعدادا لدخولها لكان طريقنا أقصر وهدفنا أقرب.
ويبقى المشهد المرتقب فيما لو بقي النظام متماسكا في دمشق، هو أنه عند تحرير حلب سيتم الزحف باتجاه دمشق مدينة بعد مدينة، وهذا ما سيطيل المعركة ويستنزف الثوار في وقت ربما يجف فيه الدعم عنهم بفعل أطراف خارجية وهم في طريقهم إلى العاصمة. وسيفتك النظام بمدينة تلو أخرى حتى يصل الزحف إلى دمشق.. عندها لن يتورع النظام عن قصف دمشق من قمة جبل قاسيون ليفتك بها وبأهلها ويعيد مشهد ما صنعه الفرنسيون في قصف دمشق عام 1925. لكن الاستراتيجية الأفضل تبقى هي دعم دمشق، وريفها المحيط بها خاصة، بما يجعلها قادرة على قطع رأس الأفعى وحسم المعركة.