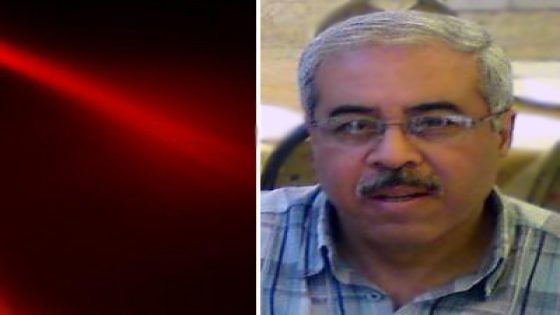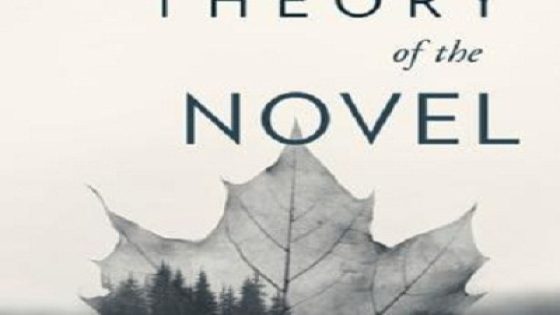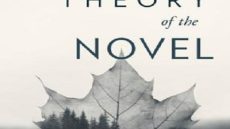بقلم: ماجد كيالي
بقلم: ماجد كيالي
لم تندلع الثورات الشعبية العربية، في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، في ظروف مواتية، أو في بيئات مؤهّلة، كما أنها لم تكن منظمة أو مبرمجة، مما يفسّر كل النواقص والثغرات والمشكلات الناجمة عنها.
لكن هذا القول لا يترتّب عليه نزع شرعية هذه الثورات، لأن البديل عن ذلك هو تأبيد حال الموات في الواقع السياسي العربي، واستمرار تهميش المجتمعات، ذلك أن المفاضلة التي سادت، طوال العقود الماضية، كانت بين حدّين، فإما القبول بالواقع مما يعني الاستكانة لحال الموات، وإما مصارعة الموت من أجل الحياة.
هذا يفيد بأن الثورات كانت بمثابة ضرورة تاريخية، أو محطّة إجبارية، لكسر حال الاستعصاء في التطوّر، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في البلدان العربية، والمتمثلة بنظم الاستبداد والفساد التي هيمنت طويلاً على البلاد والعباد. وقد توضّح ذلك جلياً في مدى ممانعة ومقاومة النظم المعنية لعملية التغيير، والثمن الباهظ الذي دفعته هذه الثورات، وما زالت، لا سيما في محطّتيها الليبية والسورية.
وبداهةً فإن القول المذكور يترتّب عليه، أيضاً، إعمال النقد في هذه الثورات، أي في خطاباتها وبناها وعلاقاتها وأشكال عملها، ذلك أن الثورات هي أصلاً حالة نقد، وهي بوصفها كذلك تنقد نفسها، أيضاً، فما بالك إذا كانت هذه الثورات جاءت، من الأصل، عفوية، بكل معنى الكلمة، وبمعزل عن أية نظرية وأي تنظيم، ومن دون أي خطة؟
في هذا الإطار، ربّما أن الثورة السورية المستحيلة والأكثر إدهاشاً، بين الثورات الحاصلة، على التعقيدات والصعوبات، والعذابات والتضحيات المبذولة فيها، هي أكثر الثورات التي توجب الملاحظة وتستحقّ النقد، رغم البطولات الكامنة في معانيها.
هكذا، وبعد تجربة عام ونصف، تبيّن بأن الثورة السورية باتت في مواجهة تحديات وتخوّفات عدّة، مما يمكن القول معه، بأن مصير هذه الثورة، أو سلامة مقاصدها، بات يتوقف على كيفية مواجهتها لهذه التحديات وتذليلها لهذه التخوّفات.
وتتمثّل أولى هذه التحديات والمخاوف، في صعود ظاهرتي العنف والعسكرة في الثورة، وهما ظاهرتان مترابطتان، ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى. فمن المفهوم أن هذه الثورة كانت انتهجت الوسائل السلمية في التغيير السياسي، وفي تطلّب الحرية والكرامة والعدالة، بينما واجهها النظام بأقصى أشكال العنف والتنكيل، الفردي والجماعي، ويأتي ضمن ذلك زجّ الجيش في هذه العملية (إضافة إلى الأجهزة الأمنية وما يسمى جماعات الشبيحة غير القانونية).
وهكذا فإن ردّة الفعل المتمثلة بانتهاج الحل الأمني، ونبذ أي حل سياسي حقيقي، من قبل النظام، هي التي شكّلت الأساس لردّة الفعل المقابلة، والمتمثلة بانزياح الثورة السورية من السلمية، إلى تبني أشكال عنفية.
بالمحصلة فقد تطورت هذه الظاهرة مع تطور وسائل النظام في قمع الحالة الثورية، فظهرت في البداية كنتاج لانشقاق عسكريين، رفضوا المشاركة في عمليات القمع، ثم على سبيل تشكيل مجموعات مسلحة لحماية المتظاهرين، والأحياء الساخنة المستهدفة، وهي المرحلة الدفاعية، وصولاً إلى المرحلة التي باتت فيها هذه المجموعات تتخذ مبادرات هجومية على بعض الحواجز والمراكز الأمنية لإرباك قوات النظام واستنزافه.
مع ذلك لا ينبغي المبالغة في احتساب قوة الجماعات المسلحة، سواء انتمت إلى “الجيش الحر” أو إلى غيره، لا من حيث العدد، أو التسليح، ولا من جهة الأهلية، ولا سيما بالقياس للقوة العسكرية التي يمتلكها النظام، كما لا ينبغي المساواة بين الطرفين في القدرة على الحركة والسيطرة والقدرة النارية والتدميرية.
وتكمن خطورة دخول الثورة السورية على خط العنف، في تآكل أشكالها الجماهيرية، وضمور طابعها السلمي، وغلبة طابعها العسكري على طابعها المدني، وفي إمكان طغيان البنى العسكرية للثورة على بناها السياسية، وفي احتمال سيادة لغة العنف في العلاقات الداخلية، أي بين القوى المكونة للثورة، أو للهيمنة على المجتمع، وهي مخاوف وتحديات كشفت عنها خبرات التجارب الثورية المسلحة، وضمنها الجزائرية والفلسطينية. وبديهي، فكلما كانت الثورة سلمية أكثر كان الوضع أسهل بالنسبة للثورة في المستقبل، وكلما كان الأمر بالنسبة للمجتمع يقينياً وتصالحياً وسليماً أكثر.
التخوّف أو التحدي الثاني، يتمثل في التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الثورة، لا سيما الثورة العنيفة، وهذا يشمل عنف النظام وعنف الثورة، على وحدة المجتمع. إذ إن الثورات غالبا ما ينجم عنها تشقّقات أو حتى تصدّعات في المجتمع، الأمر الذي قد يصعّب عليها مستقبلاً صوغ الإجماعات الوطنية في دولة ما بعد الثورة.
هكذا، لم يعد سرّاً أن الثورة السورية كسرت كل الصناديق المقفلة، وكشفت كل السرديات المسكوت عنها، وأنها بيّنت بطريقة فجّة وربما تصادمية بأن وراء هذه اللحمة المشهدية الظاهرة، قصص وروايات، وانتماءات وعصبيات، شتّى وكثيرة، لم تخفف منها لا ادعاءات “القومية” البعثية، ولا شعارات الوحدة الوطنية، التي كانت تصدرها منظمات الطلائع والشبيبة والاتحادات الشعبية، وكذا وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية.
هكذا اكتشف السوريون فجأة ذاتهم مختلفين ومتعدّدين، واكتشفوا في غضون ذلك أن ستة عقود من الاستقلال، وخمسة عقود من حكم الحزب الواحد، القومي، لم تفتّ في عضد انتماءاتهم قبل الوطنية (الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية)، مما يتطلّب إعادة اكتشاف ذواتهم الجمعية، وصوغ سردية وهوية وطنية مشتركة، كي تكون المجتمعات مجتمعات حقا، وكي تكون الدولة دولة حقاً، أي دولة مؤسسات وقانون ومواطنين أفراد.
وكما قدمنا فإن مشكلة الثورة أنها تفكك وتهدم، بطريقة صادمة، مما يفسّر كل المخاوف التي تتعلق بإمكان هيمنة أو غلبة طرف على آخر، وهي لاشكّ مخاوف مشروعة، وواقعية، لكن هذا الأمر، أيضاً، يرتبط بمدى انخراط كل الأطراف في الثورة، ذلك لأن وقوف طرف ما، بحجة ما، خارج الحراك الثوري، أو ربما ضده، قد يسهل على الأطراف الأخرى إزاحته، أو تقليص مكانته في واقع ما بعد الثورة.
نقول يسهّل لأن ذلك ليس حتمياً أو شرعيّاً فضلاً عن أنه مرهون بمدى قدرة الثورة على نفي الواقع القديم وإحلال واقع جديد، بمعنى عقد اجتماعي جديد، حيث تتأسس الدولة فيه، على مكانة المواطنين، الأفراد الأحرار، لا على الجماعة الإثنية أو الدينية.
التحدي والتخوّف الثالث، يتعلّق باحتمال التدخّلات الخارجية، السياسية أو العسكرية. وقد يصعب الحديث عن أيهما أخطر على مستقبل سوريا، هل التدخل الخارجي العسكري؟ أم التدخل الخارجي السياسي؟ فكلاهما يقومان على التدخّل، وهذا لا بد أن يكون على حساب مصلحة السوريين، وبما يتناسب ومصالح الأطراف الخارجيين.
وقد يبدو التدخل السياسي ناعماً وأقل كلفة من الناحيتين المادية والبشرية، ولكنه أكثر خطورة وكلفة من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وبالمقابل فقد يكون التدخل العسكري خشناً وقاسياً ومكلفاً من الناحيتين المادية والبشرية، في حين قد تكون كلفته أقل من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
في كل الأحوال، كلما كانت قوى الثورة السورية أكثر انسجاماً، وتماسكاً، وتتمتع بأهلية أفضل في تحكّمها بأحوالها، وإدارتها علاقاتها، وصوغها لتحالفاتها الخارجية، وتمكّنها على الأرض؛ كانت أكثر قدرة على فرض ذاتها، وعلى التقليل من شأن أية تأثيرات أو حتى تدخّلات خارجية. مع ذلك ينبغي التمييز هنا بين كون الثورة السورية حاجة وضرورة داخلية، وبين سعي القوى الخارجية للتدخل في سوريا، بالنظر لاختلاف الأهداف والمصالح والرؤية.
كما ينبغي التمييز بين الطلب من القوى الخارجية التدخّل، وهو أمر غير جائز، وغير محبذ، وبين السعي لكسب تعاطف هذه القوى، وجلب الدعم منها. وما ينبغي إدراكه أن القوى الخارجية لا تتدخل لسواد عيون أي شعب، وإنما تتدخل لأن مصالحها تملي عليها ذلك، أو ربّما لأن الوضع بات ضاغطاً ويثقل عليها أمام شعبها.
التخوّف أو التحدي الرابع، وهو يتمثل بالواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي بات المجتمع السوري يعاني منه الأمرّين، ذلك لأن استمرار الحراك الثوري طوال عام ونصف، وبسبب من انتهاج الحل الأمني من قبل النظام، أدى إلى تفاقم مشكلات الفقر والبطالة وتوقف الأعمال، وارتفاع الأسعار، وغلاء أجور السكن، وانهيار قيمة العملة، والنزوح من منطقة إلى منطقة؛ هذا دون أن نتحدث عن فقدان عوائل لمعيلها، أو لمنزلها أو لأملاكها، وهذه قد تعد بمئات الألوف. وبديهي أن فترات الاضطراب والقلاقل السياسية والأمنية ينشأ عنها حالة من البلبلة والفلتان الأمني والتحلل الأخلاقي، الأمر الذي يفاقم من تدهور الأحوال الاجتماعية والمعيشية.
صحيح أن الثورة السورية استطاعت إلى حدّ ما إنتاج أشكال معينة من التضامن الاجتماعي، التي حاولت التخفيف من معاناة المتضررين، لكن هذه الحالة تصعّب على الثوار عملهم، وتفاقم التحديات التي تواجههم، وتضاعف مسؤوليتهم، مما يعني أن المسألة الاقتصادية ستظل تحدّياً يلقي بثقله على الثورة السورية وعلى سلامة مستقبلها.
أما التخوف أو التحدي الخامس، فيتمثل بكيفية إدراك الثورة، والثوار، لأهمية إطلاق ثقافة وسلوكيات المصالحة في المجتمع، بعد كل ما جرى. وفي الواقع فإنه من الصعب الحديث عن مستقبل آمن ومستقر لسوريا بدون تكريس قيم التسامح والمصالحة في إدراكات السوريين وفي وعيهم السياسي والثقافي، لكن ذلك ينبغي أن يؤسّس على قاعدتي الحقيقة والمصارحة، لأن الاعتراف المتبادل، وكشف الحجابات عن كل القصص المسكوت عنها، هو الذي يؤسس للانفتاح، وهو الذي يمهّد لخلق واقع من التسامح والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع، أي على أساس الاعتراف بمظالم الماضي، والانطلاق معاً من المصلحة المشتركة لبناء مستقبل أفضل وآمن للجميع.
ثمة التحدّي أو التخوف السادس، ويتمثل بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة لقضية المكوّنات الإثنية الأخرى، ولا سيما للقضية الكردية، إذ لم يعد مقبولاً إبقاء هذا الجرح نازفاً، ولا إبقاء الأكراد في دائرة المظلومية، ولم يعد مقنعاً هذا الطمس للقومية الكردية، لا سيما أن الأكراد ليسوا وافدين، وإنما هم مكوّن أصيل من مكونات الشعب السوري.
ومعلوم أن حل القضايا القومية ما عاد يفترض الانقسام حكما، فقد باتت ثمة حلول إبداعية لها، لا تنتقص من عروبة السوريين، ولا من كردية الأكراد، وذلك بإقامة دولة ديمقراطية تتأسّس على المواطنين الأفراد الأحرار المتساوين أمام القانون، بدون تمييز من أي نوع؛ حيث تغتني هكذا دولة وتصبح أكثر حيوية بفضل التعددية والتنوع الكامنين فيها.
يبقى التحدي السابع، ويتعلق بتعريف دور سوريا وتحديد مكانتها في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تبوأت في العقود الماضية أدوارا إقليمية بالغة الأهمية والخطورة، وأكبر من حجمها، ومن قدرات شعبها على التحمّل.
وبالنتيجة فإن سوريا هذه التي كانت في فترة ما تمتلك أوراق لبنان وفلسطين والعراق، وحتى إيران، كليا أو جزئيا، لم تنجح تماماً في كل ذلك. هكذا فقد تحوّلت كل ورقة من هذه الأوراق إلى عبء عليها، وعلى شعبها، بل إن كثيرا من هذه الأوراق وضعت سوريا في خانة الاستهداف والاستنزاف، من دون جدوى أو عوائد ملموسة، لا سيما على الشعب السوري.
ليس القصد من ذلك التخفّف من دور سوريا الإقليمي، وإنما القصد وضع مصالح سوريا في الأولوية، والأخذ بالاعتبار التوازن بين إمكانيات سوريا، وبين محاولاتها فرض ذاتها كفاعل في مجالها الإقليمي.
وبديهي أن ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار التحدي الذي تواجهه سوريا باعتبار أن لديها أراض محتلة، ينبغي استعادتها، وأن على حدودها الجنوبية ثمة دولة معادية، هي إسرائيل، مما يفرض عليها تأهيل ذاتها لكبح جماحها، فضلاً عن مسؤوليتها إزاء تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. حقاً، ثمة للثورة السورية تحديات ومخاوف كثيرة ولكنها تعدّ بتوقعات وآمال كثيرة أيضاً.